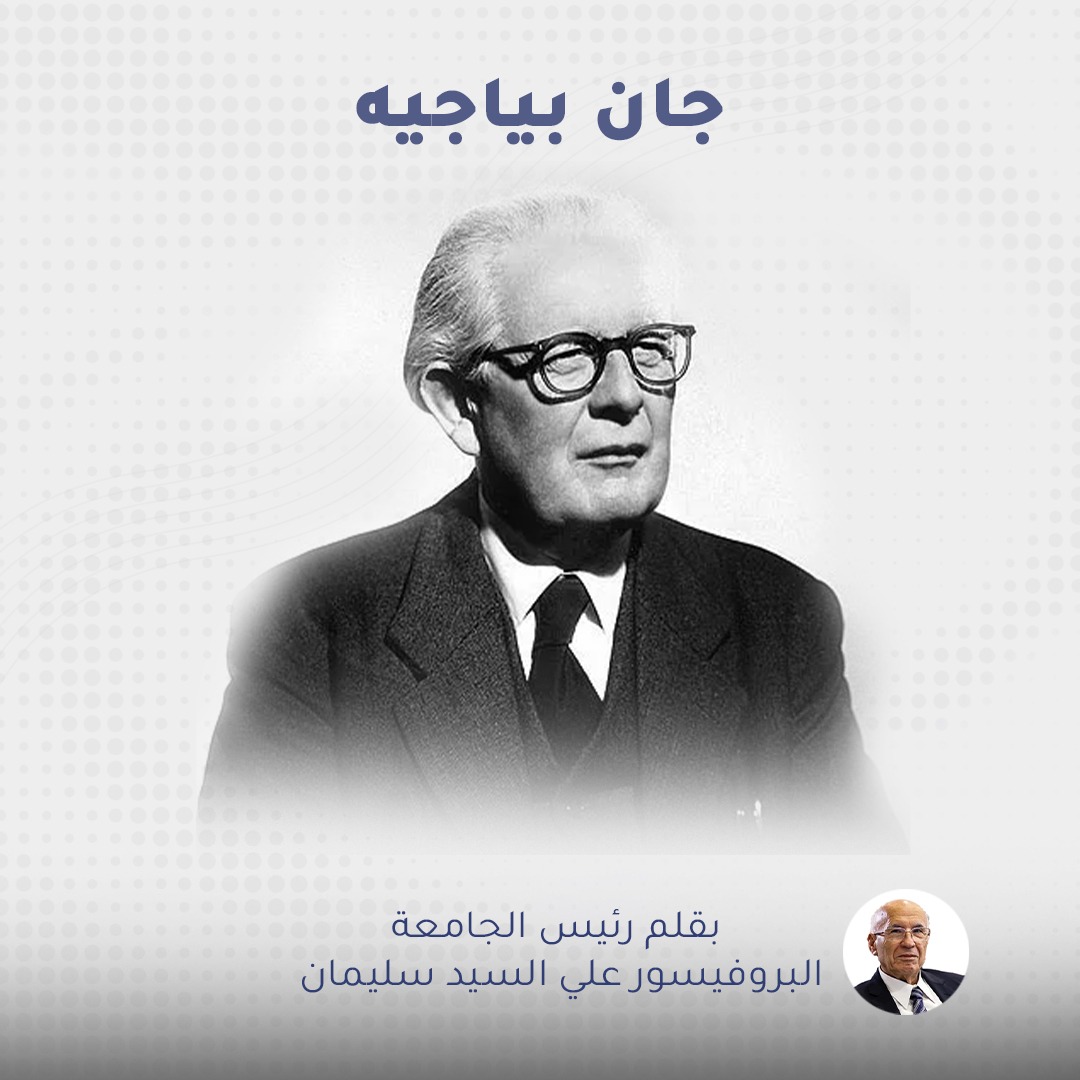
جان بياجيه
منذ 5 أشهر
بقلم : رئيس الجامعة أ.د. علي السيد سليمان
في عام 1973 احتفل نادى هارفارد Harvard Club باستقبال شخصية علمية مرموقة دعيت لتسلم جائزة دولية مقدارها 25000 دولارا أمريكيا اعترافا بتفوق حائزها وتميزه فى الإنجازات العلمية.
وقف الجميع احتراماً لهذه الشخصية المرموقة وتقديرا لما توصل اليه هذا العالم السويسري الكبير من علم نشره على العالم.
إنه جان بياجيه.
لقد طلع على العالم بفكر ثوري في نظرية المعرفة هز الكثير من الآراء المتواترة في ذلك الوقت في العلوم النفسية.
قال قبل أن يتسلم جائزته
في تواضع مداعبا العلماء الحاضرين المتمكنين من علمهم والواثقين من
أنفسهم: أن اللجنة التي تخيرتني تحيرت
لأي عالم في فروع العلوم تمنح الجائزة.
والظاهر أنني كنت من أخرجهم من
هذه الحيرة فتخيروني لها وانتهى المأزق
الحرج في حساسيته بابتسامات
ورضى من علماء من تخصصات علمية
مختلفة.
وتقدم من سيسلمه الجائزة قائلا ردا على بياجيه "أنها دعابة طريفة لطيفة أضحكتنا جميعا ولكن خياله جمح بعيدا إذ أن واقع الأمر أن اللجنة بالإجماع رشحته للجائزة ولم يكن اختياره خروجا من مأزق، إذ كيف يمكن لعلماء ألا يقدروا جان بياجيه صاحب الفكر المتميز الذي خرج به إلى العالم ولم يسبقه إليه أحد؟"
يقول زميل له في تمجيد لهذه الشخصية الجامعة، "أن بياجيه متخصص في علم الحيوان من واقع دراسته، وضليع في نظرية المعرفة بطبيعة مهنته ، وهو رجل منطق بأسلوبه في البحث والدراسة" . وقد عرف عن بياجيه عزوفه عن المقابلات الثنائية حيث كان يفضل اللقاءات التي تتيح له الفرص للتحدث عن عمله وانشغاله المرتبط بذكاء وتفكير ولغة الأطفال.
أن ما أنجزه هذا العالم الفذ في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين ودعم بثبات ورسوخ في العقد الثالث لم يجد مساحة تتناسب مع ضخامته وأهميته، ربما كان السبب هو حاجز اللغة إذ انه لم يكتب ولم يتحدث ألا بالفرنسية. حيث ضاق النطاق وانحصر في المتكلمين بتلك اللغة، ولم تتنبه المحافل العلمية إلى تلك الكنوز ألا في بداية الستينات عندما ترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية.
وحتى من قرأ بياجيه وعنه من الأمريكيين. في منتصف القرن. لم يهتموا كثيرا بما كتب. كما أن ما ترجم له في ذلك الوقت لم تحترمه المجلات العلمية، ذلك لان شيئا هاما كان مفتقدا. فقد اعلا الأمريكيون من شأن الأرقام والإحصاءات ورفعوها إلى مراتب عليا، بل وقدسوها فسيطرت على تفكيرهم العلمي حتى أصبح الإنسان مجرد رقم احصائي. ولعل خلو دراسات وأبحاث بياجيه من الإحصاءات وجداولها ومن الأرقام ومعاملات الارتباط ومستويات الدلالة والنسب القائمة والانحرافات المعيارية ... الخ لم يجد قبولا في دوائر المهتمين فلم تنشر أبحاثه ولم تنتشر.
وربما كانت الساحة التربوية وصيحات أولياء الأمور تمهد إلى استقبال شيء منير كرد فعل فجرته تلك الأقمار الصناعية الروسية التي تسبح في الفضاء.
ومن الفضاء سطع برق خاطف للأبصار. ودوى رعد يصم الأسماع. فقد تناقلت الأوساط النفسية والتربوية ما توصل إليه ذلك العالم السويسري الفذ. فماذا في نظرية وعمل بياجيه ما جعله يرتفع إلى تلك المنزلة السامية في صعود صاروخي على الرغم من بعض آرائه وأفكاره التي أثارت جدلا.
لماذا هذا الحماس الهادر لبياجيه على الرغم من أسلوبه وطريقته ومنهجه في البحث مما لم يعجب ما درج عليه الكثيرون من العلماء الأمريكيين؟
قد يكمن السر في أنه يصف كيف يفكر الأطفال وكيف يتعرفون على العالم من حولهم. ويصف ذلك بطريقة تجد قبولا وتصديقا من كل من يسمعها، فعندما يقول بياجيه أن الأطفال يعتقدون أنهم عندما يخرجون في نزهة ليلية والقمر ساطع في السماء أنه يتبعهم خطوة خطوة، كما يعتقدون أن الأحلام تأتى إليهم وهم نيام من خلال النافذة، قد يبدوا لنا هذا الوصف غريباً، ولكنه في الوقت نفسه يتوافق مع بعض مشاعرنا وأحاسيسنا الداخلية .
إن هذه الأفكار ليست فطرية عند الأطفال بدليل أنهم يتخلون عنها عندما يكبرون، وهي ليست مكتسبة إذ لم يعلمها لهم أحد من الكبار، وقد أدت محاولات بياجيه للتعرف على مصادر هذه الأفكار (الغريبة ) عند الأطفال إلى تكوين نظريته الثورية عن المعرفة .
آراء ونظريات سابقة على بياجيه
التصوير .... وجهاز العرض:
كانت هناك آراء وأفكار عرفها العالم عن الطفل ونموه العقلي والنفسي وعن لغته وتفكيره ... الخ. ويتلخص ما كان سائدا قبل آراء بياجيه في نظريتين لهما وجاهتهما ودلالتهما فيما يتعلق بالتحصيل المعرفي:
1- نظرية (كاميرا التصوير):
يعتقد أصحاب هذه النظرية في المعرفة أن العقل يعمل كما تعمل آلة التصوير عند التقاطها الصور، وهذه النظرية تبنى على مسلمة أن هناك واقع خارج عقل الطفل وهو منفصل عنه. وأن كاميرا العقل تلتقط صوراً لهذا الواقع. وهذه الصور تختزن مكونة رصيد عقل الفرد. ولكن الموجود في عقول الأفراد متفاوت. فان ما اختزن في ذاكرة الطفل أقل في الكم مما اختزن في ذاكرة الراشد. ويمكن تفسير الفروق الفردية في الذكاء بتأثير نوع الكاميرا ونوع الفيلم. إذ أن آلة التصوير الجيدة مع الفيلم شديد الحساسية يعطيان صوراً أكثر وضوحا ودقة. والكاميرا غير الجيدة مع الفيلم الرديء يلتقطان صوراً باهته غير محددة المعالم. نتاج هذا أطفال أذكياء وأطفال أغبياء ومتوسطون.
2- نظرية جهاز العرض – Projector :
وهى نظرية فى المعرفة أقل شيوعا ولا تستهوي الكثيرين، وترى أن العقل لا يعمل كآلة تصوير، ولكن كجهاز عرض صور. ويرى أصحاب هذه النظرية أن الأطفال يأتون إلى العالم وقد زودت عقولهم بمكتبة تحوي العديد من الأفلام والمعلومات وهبتها الطبيعة لهم.
وترى هذه النظرية أن العالم الذي يعيش فيه الفرد ليس فيه شيء جديد. اذ أن كل ما فيه مختزن في عقله (في مكتبة الأفلام) . وآلة العرض (العقل) تعرض في الوقت المناسب صوراً عن ذلك العالم. ليس هناك جديد وإنما العقل يستدعى ما هو موجود فيه. أي أن آلة العرض تعرض أحد الأفلام التي ولد الطفل وهو مزود فطرياً بها. والفرق بين عالم الراشد وعلم الطفل يمكن تفسيره بان عقل الراشد يعرض افلاماً أكثر مما يعرضه عقل الطفل. وتتوقف الفروق بين الأفراد على نوعية آلة العرض من حيث الجودة والنوع. أو تتوقف على طبيعة ومحتوى الأفلام.
إذن فهناك نظريات لكل معالمها الواضحة. الأولى ترى أن عقل الفرد خاو وتأتيه المعلومات من الخارج، والأخرى ترى أن الطفل يولد وفى عقله ميراث بشرى من الخبرات التي يرثها من الأجيال السابقة.
لقد بدأ الجدل قديما بين أفلاطون وارسطو. حيث اعتقد أفلاطون أن العقل والروح لا يفترقان ولا يمكن أن يفترقا، وانهما يبعثان المرة بعد الأخرى في أجسام مختلفة. وعندما ينتقل العقل من جيل إلى جيل فان الحكمة تتراكم في ازدياد عبر العصور. وإنها بهذه الصورة موجودة وتحت الطلب. على هذا الأساس فالتعلم عند أفلاطون عملية يعيد فيها العقل – المشكل سابقا – تجميع ما تعلمه خلال مرات بعثه وحلوله في أجسام سابقة. من فكرة أفلاطون هذه جاءت كلمة education (تربية) وتعنى (أن نستخرج من) أي استخراج شيء موجود، والمفروض أن هناك حكمة متراكمة موجودة وهذه تسحب من الأعماق إلى السطح والخارج .
وأرسطو لم يعجبه هذا الكلام ورأى أن كل طفل يولد بروح جديدة وبعقل لم يتشكل بعد، وعلى الرغم من أن للمولود غرائز حيوانية، فانه أي المولود، لا يحمل مع ميلاده معرفة سابقة. وعلى ذلك فالتعلم – حسب رأى ارسطو – هو عملية وضع المعرفة في عقل فارغ – أو قل خام ليس به من المعرفة شيء – ولكنه قابل لتقبل هذه المعرفة، ومن فكرة أرسطو جاءت كلمة instruction ( تعليم أو تدريس) ومعناها تزويد أو تأثيث كما تؤثث شقة فاضية.
ولا يجد رأى أفلاطون ترحيبا من علماء التربية، ولكن فكرته عن العقل المشكل سابقا كموقف مضاد للعقل غير المشكل مازالت تستهوي بعض الدارسين والباحثين.
نحن هنا أمام فكرتين، الاختلاف بينهما واضح وعميق، وتكاد فكرة آلة العرض تنبئ عن اتجاه أفلاطون في نظرته المثالية. وتكاد فكرة آلة التصوير تكشف عن نظرة أرسطو الواقعية.
ثم يفاجأ القرن العشرين برأي يخالف النظريتين الآليتين (آلة التصوير– وآلة العرض). وهو رأى يتلخص فيما يلي:
إن المعرفة البشرية هي عملية بنائية ابتكاريه. أي أن الأطفال يكونون واقعهم من خلال خبراتهم مع البيئة، بالضبط كما يرسم الفنان لوحة نابعة من انطباعاته وتأثره بالبيئة المحيطة به.
ليست اللوحة الفنية مجرد انعكاس لانطباعات الفنان، كما أن صورة شخص يرسمها فنان هي أكبر من مجرد رسم لقسمات وجه هذا الشخص. أن عبقرية الفنان تظهر في هذا المزيج الرائع من خبرته السابقة التي اصطبغت في حساسية فائقة بخياله المرهف.
وهذا ما يحدث في عقل الطفل عندما يُكوًن ويبنى واقعه. إذ أن فهمه ووعيه بما هو موجود في الواقع لا يطابق مطلقا ما تستقبله حواسه من انطباعات، فهذا الفهم يتأثر بطريقة الطفل في تكوين المعرفة التي يستوعبها عقله ويحتفظ بها، حتى تصبح جزء من مكونات ذاكرته.
الطفل يعيد بناء الواقع الذي التقطته حواسه من البيئة:
يقول بياجيه، نحن لا نعرف حقا البيئة، ولكن نعرف ما صارت إليه في عقولنا".
الواقع هو دائما إعادة تكوين ما هو موجود في البيئة ... وليس مطلقا مجرد نسخة منها.
ليس الطفل مصغر (رجل صغير). وليس الفرق بينهما في كمية الصور التي التقطها عقل كل منهما، ولا في عدد الأفلام التي يعرضها عقل كل منهما.
وإنما الفرق في كيفية بناء الواقع الذي تستقبله الحواس، وإعادة بنائه عشرات المرات، عملية البناء وإعادة البناء عند الطفل قوتها محدودة وتزداد بزيادة خبراته وسنوات عمره.
كان هذا ما فاجأ به جان بياجيه العالم .
بالإضافة إلى سحر طبيعتها، فلعل من أهم ما تتميز به سويسرا هو ذلك العدد المذهل بالنسبة لسكانها الذين كانوا يبلغون حينها مليوني نسمه (الآن حوالي تسعة مليون نسمة أو أقل)، من العلماء الكبار التي أخرجتهم للعالم. ومن الغريب أن معظمهم في مجال علم النفس. منهم على سبيل المثال ممن يندرجون في قائمة القمم .... كلاباريد Claparede الذي سبق بياجيه بسنوات وزار مصر وكتب تقريراً عن التعليم فيها. وكارل جوستاف يونج Carl Gustav Jung في مجال التحليل النفسي. وهيرمان رورشاخ Herman Rorschach صاحب اختبارات بقع الحبر (الاختبارات الاسقاطية) وجان بياجيه Jean Piaget موضوع هذا الحديث، فهل يمكن تفسير ذلك من خلال العوامل البيئية المتمثلة بالطبع في ظروف الحياة السويسرية ومن خلال وتأثير الجينات الوراثية أو القول بأنهما جميعاً أدت إلى هذا التفوق الكبير في العلوم النفسية والاجتماعية. مع صغر عدد السكان النسبي.
عام 1896م وفي قرية صغيرة خارج لوزان تعرف باسم نيوشاتيل ولد جان بياجيه من أب يعمل أستاذا لتاريخ العصور الوسطى بجامعة لوزان، ومن أم شديدة التدين في تمسك عميق بالمسيحية. وكانت الأم دائما لا تستريح لتلك الآراء الغريبة عن مفاهيمها والتي يؤمن بها ذلك الأستاذ الجامعي الذي آمن بعقلانية معينة لم ترض زوجته. وكثيرا ما تعرض الطفل جان إلى مواقف سمعت فيها أذناه ذلك الجدل بين موقفين الاختلاف فيهما يكاد يكون حادا، وعندما بدأ عقله يعنى أطرافا من تلك العبارات المتداولة بين أمه وأبيه، ازداد الموقف بالنسبة له تعقيداً، فهرب منه إلى اهتمامات تشغل تفكيره، حتى ينفض عنه هذه المصادمات الكلامية التي ملآت جو البيت في مجادلات لا تكاد تنتهي، كما شجعته على ذلك قدرات عقلية كانت تتلهف شوقا لترجمة الإمكانية إلى تعبير. وربما كان التفاعل بين هذا الاغتراب المنزلي مع تلك القدرات المنطقية المتحفزة دافعا إلى محاولات لكشف واستجلاء أشياء أثارت الكثير من تساؤلاته. وأن ثمة شيئا في داخله يمكن أن تسميه ( المارد) تحرك في عنف وفى جسارة اللهفة، بل وفى تحد لهذه البيئة الاجتماعية طالبا الانطلاق إلى تفكير عقلاني في أمور محسوسة بدأت تستحوذ على عقل وتفكير هذا الطفل الذي ينمو عقليا بسرعة غير عادية. ربما كان القدر يخطط طريقا لميلاد عبقري يعتبر واحدا من قمم علماء النفس في العصر الحديث.
وقد أثبتت مراحل نمو بياجيه العقلية تنبؤات القدر. إذ ظهرت سمات هذا التفوق العقلي العلمي عندما كتب (وهو في سن العاشرة) مقالا في مجلة علمية لها وزنها عن عصفور نادر من عصافير جبال الألب. وجذب هذا المقال أنظار المهتمين – ربما لأسلوبه العلمي والموضوعي الذي كان جديراً بالاهتمام. أية روعة تلك التي تتسلل إلى قلب وعقل هذا الطفل؟ كان الأمر كله بالنسبة له رائعا ومثيراً.
وكان من الأمور النادرة القليلة التي يجود بها القدر في أوقات لا يعلم متى تكون، ولكنها تكون. إذ كيف لهذا الصبي وما يزال في طريقه إلى التعلم والتحصيل أن تنبثق من داخله شعلة وضاءة فتنجلي أمام عينيه أموراً علمية– ربما استعصت على بعض المتخصصين فإذا هو يكتب في براعة عن الرخويات ويعمل في متحف كمتخصص له الدراية الجيدة في عملة والتي أرضت رؤساءه .... وكتب .... وكتب ... مما أثار الإعجاب ولما يبلغ السادسة عشرة. وأن ثمة شيئا مبشرا، قد يكون نذيرا يعتمل في عقل هذا المراهق اللامع وهو يخطو بكل الثقة إلى مشارف النضج.
كانت دلائل تلك الألمعية العلمية وهو يعمل مساعدا لأمين متحف الرخويات ثم مسئولا عن قطاع خاص به، أنه كان يدون في دقة علمية ما يلاحظه ومما يراه في سلوك كائنات حية هي الرخويات على شاطئ البحيرات. وتبلورت ملاحظاته في مجموعة مقالات نشرتها مجلات متخصصة في علوم الأحياء. وذاع صيته إلى الدرجة التي أضفت عليه صفة (عالم) في الرخويات. وفرش الطريق بالورد أمامه عندما عرض عليه أن يكون أمينا لمتحف في جنيف... جنيف المدينة الكبيرة، لمتحف له صيت مدو، ولكنه لم يستطع تبوأ هذا المقعد الضخم فقد كان في سن السادسة عشرة ولم ينه بعد مرحلة التعليم الثانوي. هي روعة في قمة.
حتمت ظروف معينة على بياجيه الاكتفاء بعمليات الملاحظة الدقيقة للنبات والحيوان، ولكنه لم يستطع أن يمارس التجارب المعملية. فقد كانت بيديه علة تهدد التوافق في الحركات والدقة المطلوبة في التجريب المعملي في علم الحياة. وكانت لبياجيه اهتمامات عقلانية في الفلسفة وخاصة فيما كتبه ارسطو وبيرجسون . وبالذات فيما كتب عن علم الأحياء والعلوم الطبيعية. وقد أثار انتباهه رأى بيرجسون فى الثنائية بين قوى الحياة والقوى الطبيعية ولم تعجبه هذه الثنائية، ولكنه أعجب بموقف أرسطو وهو يكتب في العلاقة بين الكائنات الحية وغير الحية وإنها كلها تخضع لقوانين تتسم بالمنطقية. وفى رأى بياجيه أن الذكاء البشرى هو الذي استطاع بمنطق رائع أن يكتشف مبدأ الوحدة بين جميع العلوم الاجتماعية والبيولوجية والطبيعة. وكانت وجهة نظره هذه هاديا له في أعماله التي بهر بها العالم.
وفى عام 1914م عزم النية على السفر إلى إنجلترا ليتعلم الإنجليزية بين أهلها كما كان يفعل شباب عصره. ولكن الحرب العالمية الأولى اندلعت. ولم يكتب للعزم أن يخرج إلى حيز التنفيذ. وربما كان هذا هو السبب في أن كل كتاباته كانت باللغة الفرنسية. ويقال إنه كان يفهم الإنجليزية مكتوبة، ولكنه لم يكن يتكلمها.
كان تخصصه الأساسي في جامعة لوزان علم الأحياء. وكتب رسالته لدرجة الدكتوراه في الرخويات. وربما كان يحبها منذ كان يعمل في المتحف قبل التحاقه بالجامعة.
في بداية عمله بالجامعة تراءى له أن يترك كل شيء حتى يخلو إلى نفسه بعيدا عن العمل والأسرة والأصدقاء ليتأمل في صفاء التفكير. واتخذ لنفسه مكانا قصيا في أحد النزل على ربوة من ربى جبال الألب الشاهقة، وكان في ذلك الهدوء الشامل يحاور نفسه عن مستقبله العلمي. وألحت عليه الأفكار في إصرار فكتب قصة طويلة ضمنها خططا للمستقبل وكأنما هو يزيح ستائر كثيرة ليظهر ما وراءها. وكأنما كل ستارة تعبر عن عقد من الزمان. وللغرابة المثيرة أن تنبؤاته عن خطط بحثه التي اراد إتباعها في مستقبل سنواته تلك التنبؤات التي دونها في مذكراته قد تحققت.
وأيضا في بدايات عمله بالجامعة بدأ ينقب في التراث البشرى عن شيء يهمه، آملا أن يجد إنتاجا خلفه السلف يساعده على أن يربط بين اهتمامه الفلسفي بنظرية المعرفة (وهى أحد فروع الفلسفة الذي يهتم بكيفية معرفة الحقيقة Epistemology ) وعلم الأحياء – وأمضى فترة في العيادة النفسية بزيوريخ تلك التي عمل بها يونج ، وكان يلاحظ ويتعلم ويدون . وقد اهتم جان بياجيه بنظرية فرويد في التحليل النفسي، بل إنه كتب مقالا عن (أحلام الأطفال) استرعى انتباه فرويد. ولم يكن لديه أية رغبة في الاتجاه إلى ميدان التحليل النفسي. وذلك أن اهتمامه به لم يكن يعنى عنده أن يكون هذا الميدان مستقبله في حياته العملية.
وشد الرحال إلى باريس حيث عمل في المعهد الذي أجرى فيه الفريد ينيه Alfred Binet تجاربه عن اختبارات الذكاء. وقد كلف بياجيه بتقنين بعض اختبارات علم النفس للعالم الإنجليزي سيرك بيرت Cyril Burt حتى يمكن تطبيقها على الأطفال الفرنسيين. وكانت عملية إجراء الاختبارات بالنسبة له غاية في الملل، ولكن ثمة شيئا ما شد انتباهه وآثار اهتمامه ذلك أن إجابات الأطفال عن الأسئلة كان بها من الغرابة وعدم التوقع ما يثير الدهشة عنده، فقد كانت من ناحية توقع الاختبار خاطئة، ولكنها أثارت عنده تساؤلات. وعلى سبيل المثال:
سؤال: لون بشرة الطفلة هيلين أسمر من لون بشرة الطفلة روز، ولون بشرة الطفلة روز اسمر من لون بشرة الطفلة جويس. من لون بشرتها اقل اسمراراً؟
جواب: كلهن شعرهن اصفر.
الإجابات الخطأ لم تعن بياجيه بقدر ما عنته تلك العمليات العقلية عند الأطفال والتي أنتجت هذه الإجابات غير الصحيحة. ولاح له أن محتوى أخطاء الأطفال في إجاباتهم والأسباب التي أدت إلى تلك الأخطاء لم تكن مصادفة وإنما كانت نتيجة تكوين عقلي معين أدى إلى هذه الإجابات. وهذا التكوين العقلي هو المسؤول عن تكرار تلك الإجابات غير الصحيحة.
الخبرة التي مر بها بياجيه في باريس أضاءت الكثير من الشموع في طريق تساؤله وهو ينقب عن التراث البشرى فيما يتعلق بنظرية المعرفة وعلم الأحياء. وبدأت ملامح الطريق تتضح عندما ارتأى في تحليل طريقة تفكير الأطفال ما يمكن أن يشبع رغبته فيما يريد من اكتشاف تلك الصلات بين نظرية المعرفة وعلم الأحياء.
وقد ظن بياجيه أن دراسة تفكير الأطفال لن تستغرق وقتا طويلا، ولكن حدث غير ما توقع ( كما تنبأ في قصته التي كتبها في ذلك المكان البعيد فوق ربوة من ربى جبال الألب ) فقد شغلت دراسة تفكير هؤلاء الأطفال بقية حياته العلمية.
وصار بياجيه واحداً من أبرز علماء هذا القرن في علم النفس. وكان معهد جان جاك روسو في جنيف الذي عاش فيه بعد عودته من باريس يسجل مع الزمن خطوات صعوده إلى تلك المنزلة العلمية العالية وهو يبحث في نمو تفكير الأطفال، وكتب على التوالي الكتب التالية: اللغة والفكر عند الطفل – الحكم والاستدلال عند الطفل – مفهوم العالم عند الطفل – الحكم الأخلاقي عند الطفل.
وهكذا رفعت هذه الكتب مؤلفها إلى منزلة سامية بين علماء النفس في العالم. ولم يبلغ سن الثلاثين حينئذ. وكانت في رأيه ليست القول النهائي وإنما هي تمهيدات لكتب لاحقة، ومع ذلك حلا للبعض مناقشتها ومهاجمتها وما زال الرجل يلاحظ ويفكر ويكتب، وخلا مقعد مدير معهد علم التربية بجامعة جنيف باعتزال العالم ادوارد كلاباريدClaparede واختيار بياجيه ليكون المدير مع احتفاظه بعمله أستاذا بالجامعة، واحتفظ بهذين المنصبين حتى اعتزاله.
وجاءت الوفود تتري حيث كان مديرا وحيث كان أستاذا تنهل من علمه وتتعلم من منهجه. جاء الطلاب ليتتلمذوا على هذا العالم القدير. وكانت فالنتين إحدى طالباتة التي تزوجها بعد ذلك لينجب منها ثلاث أطفال جاكلين ولوران ومونيكا. دخل هؤلاء الأطفال تاريخ علم النفس عندما لاحظ بياجيه وبجواره زوجته فالنتين سلوك أطفالهما ... ودون ملاحظاته في ثلاثة كتب:
- منابع الذكاء عند الطفل.
- تكوين الواقع عند الطفل.
- اللعب والأحلام والتقليد في الطفولة.
استطاع بياجيه من دراسة تفكير الأطفال أن يصل إلى نظرية عامة عن النمو العقلي عندهم ليتمكن بها من تفسير أسباب أفكارهم الخاطئة التي اكتشفها في دراساته المبكرة، وكيف تتحول هذه الأفكار إلى المنطقة المقبولة عندما يكبرون.
وبدى واضحا لبياجيه أنه يجب دراسة القدرات العقلية التي يستخدمها الأطفال منذ طفولتهم المبكرة في تكوين الواقع. وركز بعمق في ملاحظة اطفاله. ولم يفترض أن للطفل عالما خارجيا يحاول التعرف عليه ويتمثله، وإنما رأى أن الطفل يبنى الواقع كما يحسه، وهذا يعنى أن(الواقع) يختلف من طفل إلى آخر.
هذه النظرة إلى سلوك الأطفال سمحت لبياجيه أن يلاحظ ويدرس جوانب من تفاعلاتهم -لم تكن تحظ باهتمام العلماء من قبل - فمثلا لاحظ أن الطفل لا يبحث عن شيء يرغبه أو يريده إذا اختفى هذا الشيء عن ناظريه إلا في نهاية عامه الأول. وفسر هذه الظاهرة بأن الطفل الصغير لم تتكون لديه بعد فكرة استمرار وجود الشيء بعد أن يحجب عن حواسه.
كان علم النفس التقليدي في هذا الوقت شديد الاعتراض في قسوة على أية تلميحات تظهر في كتابات علماء النفس عن قراءة أفكار الغير أو تفسير مشاعرهم بدون تقديم الأدلة والبراهين والتبريرات على ذلك. وكان بياجيه يريد أن يضع تصوراً عن ماهية خبرة الأطفال عن العالم في هذا السن المبكر، ويريد أن يفعل ذلك بطريقة علمية مقبولة وقابلة للقياس.
أن حل هذا المشكل الصعب هو دليل آخر على عبقرية هذا العالم الفذ.
في كتاب " منابع الذكاء عند الطفل " وصف بياجيه نشوء العمليات العقلية عند الأطفال كما تلاحظ من الخارج أي في سلوكهم الظاهر. وقدم شرحا لبعض المفاهيم الأساسية في نظريته عن الذكاء، منها مفهوم التنظيم Organization
والتكيف Adaptation .
ويتضمن التنظيم عمليات التصنيف والترتيب للأشياء والعمليات والأحداث في نظام مترابط ترابطا منطقيا في عقل الطفل. فمثلا عندما يجمع الطفل الصغير بين مهارتين مستقلتين في سلوك واحد مثل (النظر إلى شيء) و( القبض على شيء) وتتولد عن هاتين المهارتين مهارة أخرى أكثر تقدما هي (التقاط شيء ينظر إليه) ... هو هنا قد صنف الأحداث ورتبها أي قام بعملية تنظيم عقلي مكنه من القيام بالسلوك االمطلوب.
ويتضمن التكيف عمليتين اخريتين وإن كانتا على طرفي نقيض إلا أن بينهما صلة وثيقة. هاتان العمليتان هما الملاءمة أو المواءمة Accommodation
والتمثيل Assimilation . وتعنى المواءمة تغيير سلوك الفرد ليتمشى مع البيئة، بينما يعنى التمثيل تغيير البيئة لتتمشى مع سلوك الفرد. فمثلا عند الرضيع نجد سلوك المواءمة واضحا فهو محتاج إلى الغذاء ولذلك يلائم فمه ليتناسب مع المصدر الذي يرضع منه، رضاعة طبيعية أو غير طبيعية. وعندما يمس شفتيه أي شيء فهو يتصوره مصدرا للغذاء وتتحرك شفتاه كأنه يرضع متمثلا هذا الشيء مصدرا للغذاء الذي اعتاده وهذا مثال من أمثلة التمثيل.
وقد استمد بياجيه هذين المصطلحين (الملاءمة والتمثيل) من العلوم البيولوجية. فان الإنسان حين يأكل يتحول الطعام عن طريق المضغ والبلع إلى مادة جديدة ويفقد صورته الأصلية وذلك حتى يمكن الإفادة منه في العملية الفسيولوجية التي يقوم بها الجسم. وعملية تغيير عناصر البيئة بحيث يمكن إدماجها داخل تركيب الكائن العضوي هي التي تعرف باسم (التمثيل) أي تمثل العناصر الخارجية لتصبح جزءاً من التكوين العضوي. ولكن الكائن العضوي أثناء قيامه بعملية التمثيل للطعام، يقوم أيضا بعملية أخرى هامة، فهو يلائم نفسه معها وبطرق متعددة خلال جميع مراحل التكيف. فالفم يجب أن يفتح، وإلا لن تمر المادة الغذائية إلى الجهاز الهضمي كله، والأسنان يجب أن تعمل لقطع الطعام ومضغه جيدا. والطعام يجب أن يبتلع، وأن تتكيف العمليات الهضمية نفسها مع الخصائص الطبيعية والكيميائية للغذاء، وإلا لن تتم عملية الهضم. أي أن الكائن الحي العضوي يتلاءم مع خصائص الأشياء التي يحاول تمثلها. ويمكن القول بوجه عام أن التمثيل يعنى أن الكائن الحي قد تكيف ويمكنه معالجة الموقف الذي يواجهه، والملاءمة تعنى أنه يجب أن يتغير من أجل أن يتكيف. والعمليتان في الواقع مترابطتان إحداهما بالأخرى، فالتمثيل يتضمن الملاءمة، والملاءمة هي في نفس الوقت تعديل تمثيلي لللشيء لتتلاءم معه .
وعملية التكيف بشقيها – التمثيل والملاءمة – تفترض مقدما وبصورة دائمة عملية تنظيم. وهذا التنظيم هو عنصر وظيفي ثابت، كما أن التمثيل هو العنصر الأخر الثابت وظيفيا.
فتمثل الكائن العضوي للطعام وتلاوم الكائن العضوي معه هي أنشطة منتظمة يقوم بها الكائن الحي وبشكل منتظم. ويتضح هذا التنظيم في علاقة الأجهزة العضوية المختلفة داخل الكائن العضوي.
وإذا انتقلنا إلى المجال العقلي أو مجال الذكاء، فإننا نجد نفس العناصر الوظيفية الثابتة التي اتضحت لنا في مجال البيولوجيا. ويذهب بياجيه إلى أن الذكاء نوع من التكيف ولا يمكن الفصل بين التنظيم والتكيف بالنسبة للذكاء – كما هو الحال من وجهة النظر البيولوجية – فهما وجهان مكملان لعملية واحدة سواء كان الكلام عن الذكاء العملي أو الذكاء اللفظى.
وكما تتضمن العمليتان البيولوجيتان عمليتي التمثيل والملاءمة، فكذلك يتضمن التكيف العقلي نفس هاتين العمليتين. والتمثيل العقلي لا يختلف كثيرا عن التمثيل البيولوجي، ففي كلتا الحالتين، نجد ان الكائن الحي يتكيف ويمكنه أن يعالج الموقف المعروض عليه. والتمثيل والملاءمة العقليان – كما هو الحال في المجال البيولوجي – عمليتان مترابطتان، فعملية الإدماج العقلي لحقيقة ما، تتضمن دائما كلا من التمثيل والملاءمة، فلتمثل حادثة معينة، فمن الضروري في نفس الوقت التلاؤم معها، والعكس صحيح.
ولقد حاول فلافيل Flavell توضيح مفهوم التمثيل والملاءمة عند بياجيه بمثال محسوس فقال لنفرض أن طفلا يوجد لأول مرة أمام حلقة تندلي من خيط، سنلاحظ أن هذا الطفل يقوم بسلسلة من الأفعال التلاؤمية، انه ينظر إليها، يلمسها، يجعلها تتأرجح يمينا ويسارا، يمسكها .... وهكذا. وهذه الأفعال لا تحدث في فراغ. فالطفل لدية خبرة سابقة من تفاعلاته مع العديد من الأشياء، وكون نتيجة لذلك مجموعة تراكيب تمثيلية توجه هذه الأفعال. يقول بياجيه "أن التراكيب التمثيلية هي صور ذهنية عامة تعد جزءا من التنظيم العقلي للطفل،" وأفعال الطفل بالنسبة للحلقة عبارة عن ملاءمات لهذه الصور الذهنية مع الواقع المحيط بالحلقة، وتمثل هذا الشيء الجديد أو دمجه واحتوائه في هذه الصورة الذهنية العامة.
أن مفهوم الصور الذهنية العامة أو (المخططات العقلية) The Schemas هو من المفاهيم الهامة والأساسية التي أوردها بياجيه في هذا الكتاب. ولم يقدم لنا تعريفا دقيقا لهذا المصطلح، ولكن يستطيع الدارس أن يستنبط المعنى من كتابات بياجيه المتعاقبة.
يقول بياجيه "أن الطفل يقوم بعمليتين أساسيتين هما التنظيم والتكيف، وتتحد هاتان العمليتان لينتج عنهما مخطط عقلي أي صورة ذهنية عامة يستطيع الطفل بواسطتها أن يفرق بين المواقف المختلفة التي يقابلها أو يتعرض لها. وكذلك يستطيع في ضوء هذه الصور الذهنية العامة أن يعمم بين الخبرات والمواقف المتشابهة."
فعندما يواجه الطفل موقفا فإنه يقارن بينه وبين مخططاته الذهنية السابقة، ويتخذ ما يلزم من تلاؤم للموقف أو تمثيل له حتى يستطيع أن يتصرف إزاءه .... ونتيجة لهذا التصرف (الجديد) تتغير الصورة الذهنية فتتضمن هذه الخبرة (الجديدة) ويصبح لدى الطفل مخططا جديدا يستخدمه في تفسير وفهم ما يواجهه من مواقف مستقبلية، ولذلك يطلق على هذا المصطلح تعبير (أنماط سلوكية) Behavior Patterns وذلك لأنها تتضمن مجموعة أفعال متتابعة ومترابطة في وحدة. وتحتوي على العناصر السلوكية المكونة لتلك الأفعال.
وعلى ذلك تتضمن هذه الصور الذهنية كلا من العمليات الحسية الحركية والعمليات العقلية والمعرفية وهي تتضمن الاستجابات البسيطة التي يمكن التنبؤ بها عمليا على مستوى الفعل المنعكس، مثلما تتضمن أيضا التنظيمات المعقدة كفهم نظام العدد.
هذه الصور الذهنية وان كانت قابلة للتكرار ألا أنها – باعتبارها تركيبا عقليا – هي تنظيمات مرنه وهي أطر متحركة تنطبق على مواقف مختلفة. وكون الصور دائمة التلاؤم مع الأشياء وهي تتمثلها فهذا دليل على مرونتها وديناميتها فهي دائمة الحركة والتغير وتزداد مع تقدم العمر.
وبعرض بيهلر Biehler مثالا يوضح فيه كل هذه المفاهيم، طفل صغير يواجه بجسم مستدير (كرة) لأول مرة .... هذا الطفل قد كون من خبراته السابقة بعض المهارات البسيطة ونظمها في تفكيره .... من هذه المهارات القدرة على أن ينظر إلى الشيء الذي أمامه، والقدرة على القبض أو الإمساك بالأشياء. وعندما يواجه بهذا الجسم الكروي يحاول أن يستخدم خبراته السابقة ويفيد منها في التعامل مع هذا الموقف الجديد، فينظر إلى الكرة ويمد يده محاولا الإمساك بها والتقاطها، ولكن محاولاته الأولى تفشل لأن هذا الشيء الجديد (الكرة) يتدحرج. ولم يعهد من قبل الإمساك بشيء يتدحرج بهذا الشكل. فيحاول التكيف مع الموقت بأن يلائم سلوكه طبيعة هذا الشيء الجديد، فيغير من طريقة امساكه بالأشياء التي أتقنها من قبل. ويتمثل المواصفات الجديدة للكرة في إطار ما لديه من صور ذهنية عن الأشياء وطرق الإمساك بها.
فإذا كانت أول كرة يقابلها صغيرة الحجم حمراء اللون، سيعتقد أن هاتين الصفتين تنطبقان على كل الكرات. أي أن كل الكرات بهذا الحجم ولونها احمر، حتى يقابل كرات أخرى من أحجام مختلفة ومن ألوان مختلفة، وتدريجيا تتغير الصورة الذهنية عند الطفل لتتسع لجميع أحجام وألوان الكرات وأن يتفهم خصائصها العامة كسهولة الحركة والدحرجة .... الخ. وفى سبيل ذلك يمر الطفل بعدة مراحل في نموه العقلي تحدث في تتابع منتظم بحيث تبنى كل مرحلة منها على المرحلة السابقة لها، وتمهد كل مرحلة للمرحلة التالية. ويعتقد بياجيه أن جميع الأطفال يمرون بهذه الخطوات نفسها وفى نفس التتابع والفروق الفردية بين الاطفال تتضح فقط في سرعة تكوين هذه المراحل والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وفى كتاب منابع الذكاء عند الطفل يؤكد بياجيه إمكانية ملاحظة سلوك الأطفال والتعرف من خلال الملاحظات الدقيقة على سمات مراحل النمو التي يمر بها الأطفال بالنسبة لنمو العمليات العقلية والذكاء.
أما الكتاب الثاني " تكوين الواقع عند الطفل " فقد اهتم فيه بياجيه بمحتوى تفكير الأطفال أكثر من اهتمامه بنمو العمليات العقلية عندهم. وقد استخدم نفس الأسلوب في البحث العلمي الذي يعتمد على الملاحظة الدقيقة لسلوك وتفاعلات الأطفال. ولكن هذه المرة حاول تبنى وجهة نظر الطفل نفسه وكيف يرى العالم من حوله، وذلك عكس كتابه الأول حيث كان الاهتمام موجها لملاحظة أساليب الأطفال كما يراها الآخرون. وكان يحاول تبرير وشرح ما يعتقد أن (الطفل يراه) أو (يدركه مما حوله) بناء على ملاحظات مرئية بعيدة كل البعد عن التفسير الذاتي. أي أنه تحًرى الموضوعية الكاملة فيما يلاحظه وما يدونه عن رؤية الطفل للعالم من حوله. ولمزيد من التأكد كان بياجيه يكرر الموقف الواحد عدة مرات وبطرق مختلفة حتى يطمئن إلى سلامة نظريته.
في هذا الكتاب تحدث بياجيه عن حاسة الأطفال بالنسبة للمكان والمساحات والزمن وعن العلاقة بين الأسباب والنتائج .... وفى كل حالة كان يضرب الأمثلة ويشرح العديد من التجارب البسيطة التي توضح مقاصده وتثرى مناقشاته عن هذه الموضوعات.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها بياجيه في هذا الكتاب أن الوليد في عمر أقل من ثلاثة أشهر لا يرى أن للأشياء صفة الدوام، فإذا اختفت عن حواسه فقد زالت. فمثلا ما اختفى عن ناظريه (أي حاسة بصره) فقد اختفى عن ذهنه. ولكن يتحول الأمر مع نموه الزمني.
وفى ثلاثية كتب بياجيه عن الطفولة المبكرة يتناول الكتاب الثالث موضوعات " اللعب والأحلام والتقليد في مرحلة الطفولة ". وفيه يقول إن الرموز التي يعبر بها الطفل عن الواقع هي نفسها تركيبات كتلك التركيبات التي تكون الواقع. أي أن الرمز المعبر عن الواقع تكون من مجموعة أشياء. وهذه الأشياء هي نتيجة مواقف مر بها الطفل وأدركها عقله واحتفظت بها ذاكرته، فمثلا عندما يرى الطفل قطعة ورق ممزقة فإنه يصفها باسم شيء رآه سابقا. كان يقول إنها فراشة لأن شكل هذه القطعة قريب الشبه، بالنسبة لنظرته ورؤيته وإدراكه هو بالفراشة، وربما يطلق عليها– حسب خبرته – اسم كسرة خبز (عيش). وعندما تفتح علبة أمامه فانه يقلدها بفتح فمه. وعندما تقفل يقلدها بضم شفتيه .... الخ أي انه يكون الرموز (وتركيباتها) من التقليد واللعب. وعلى ذلك ففي رأي بياجيه أن تكوينات الرموز عند الطفل تتمشى في نموها مع بقية العمليات التي تؤدى في مجموعها إلى نموه العقلي، وان هذه العمليات الرمزية لا تظهر قبل سن الثانية. وقد يفسر ذلك ما نلاحظه من أن الأطفال لا يقصون أحلامهم أو يحكون عن كابوس أزعجهم في نومهم قبل هذا السن. والظاهر أن الأطفال هنا ليست لديهم القدرة الفعلية على تكوين الرمز التي تكون محتوى الأحلام.
ويبدو أن بياجيه كان مشغولا جدا في الثلاثينات من هذا القرن فقد انكب في شوق واستمرارية على أبحاثه عن الأطفال في نموهم العقلي خلال سنوات العمر الأولى والتي سينتقل منها إلى مراحل عمريه أخرى. وفى الوقت نفسه كان يحاضر بالجامعة وقد بدأ صيته يعم الآفاق ويتبوأ مكانة عالمية بين العلماء، هذا إلى جانب ما قدمه من مقالات ودراسات في المنطق ونظرية المعرفة.
جذبت شهرته عددا كبيرا من الدارسين النابهين وبعضهم دخل تاريخ علم النفس ومنهم بولندية اسمها جيرترود سيمنسكا Gertrude Szeminsk وكانت متخصصة في الرياضيات والهندسة، واشتركت مع بياجيه في بحوث مستفيضة عن " إدراك الطفل للأعداد " ونشرت نتائج هذه الجهود في كتاب يحمل الاسم نفسه. ويعد من المراجع الهامة في هذا الموضوع. وكانت هناك أيضا بأرييل انهلدر Barbel Inhelder وقد كتبت رسالتها عن الأطفال المعوقين وقد اختارها بياجيه لتكون مساعدة ثم مشاركة مستديمة معه في بحوثة ودراساته .... ثم خلفته في كرسي الأستاذية بالجامعة. وكانت أول امرأة تتولى منصبا علميا هاما كهذا المنصب في سويسرا.
في بدايات الأربعينات. عندما كان بياجيه مديرا لمعهد جان جاك روسو نجحت مجهوداته في ضمه إلى الجامعة كمعهد للبحوث التربوية والنفسية، ولكنه كان حريصا كل الحرص على أن يكون ذا طابع يختلف عما عرف في ذلك الوقت عن معاهد وكليات التربية التي لم تكن لها حرية الحركة المرغوبة. وظهر ذلك جليا في البحوث البينية Interdisciplinary التي كانت تجرى فيه.
واستطاع بياجيه أن يعطى مساحة ووزنا كبيرا في برنامج إعداد المعلمين لموضوعات نمو الطفل وللبحوث الخاصة بسيكولوجيته.
وليس صحيحا أن دراسات بياجيه اقتصرت على ملاحظة أطفاله الثلاثة فقط، ربما حدث هذا وهو يدرس صغار الأطفال. وفى الواقع أن تلاميذه الكثيرين انتشروا بتوجيهاته وإرشاداته يدرسون ويبحثون يقدمون التقارير عن ملاحظاتهم لمئات الأطفال في أعمار مختلفة وفى موضوع يحدده هو.
عندما كان بياجيه يستشعر رغبة لها أساس منطقي أو عملي نتيجة دراسة سابقة دفعته إلى سؤال هام، يصبح هذا السؤال موضوعا للبحث يقتنع به بياجيه ويكرس له انتباهه واهتمامه لمدة زمنية تقل قليلا عن العام أو تزيد قليلا عنه. ويكون هذا الموضوع شغله الشاغل. ولا يستريح إلا إذا عولج الموضوع من كافة جوانبه. وفي تلك الأثناء يكون طلبته ومساعدوه ومعاونوه وزملاؤه دائما معه وحوله في اجتماعات أسبوعية لمناقشة ما يجرى في بحث هذا الموضوع.
وعندما يتجمع لديه حصاد مجهودات البحث في ذلك الموضوع يحمله إلى مكان منعزل في أحد جبال الألب السويسرية. ويتفرغ كلية لما أمامه من أوراق. ولا ينزعه من هذه الجلسة إلا رغبة في المشي على الاقدام أو طهى طبقه المفضل من (العجة) ويتطلع إلى الطبيعة الساحرة حوله، وعقله يسبقه إلى حيث الأوراق التي تنتظره في لهفة وهو يسرع إليها في شوق. وعندما ترتب وتدون الأفكار على الورق مربع المساحة وبخطه الكبير ..... تنتهي الإقامة في كوخ الجبل ويعود إلى عائلته. ثم ينشغل بميلاد فكرة جديدة تبدأ ترى نور الشمس.
بياجيه ..... ونمو الطفل.
النمو كما يراه بياجيه عملية لها صفتان:
- الصفة الأولى أن الفرد يولد وبه خاصية النمو أي أن النمو فطري عند الفرد .
- أما الصفة الثانية وهي مرتبطة بالأولى فحيث أنه فطري فلا يمكن تغييره أو التعديل في مساره وتطوره.
أي أن النمو عملية فطرية تطورية.
وتمر عملية النمو هذه في مراحل كبرى أو قل أساسية تشتمل كل واحدة منها على مراحل أصغر أو قل ثانوية. ويصف بياجيه المراحل بأنها أدوات لا غنى عنها لتحليل عمليات النمو وفهمها، وهو يقارنها بالطريقة المستخدمة للتصنيف البيولوجي.
تعكس كل مرحلة من تلك المراحل مجموعة من الأنماط السلوكية التي تحدث في تتابع محدد في حقبة تقريبية من العمر، وإتمام إحدى هذه المراحل يمهد لمرحلة جديدة. مع ملاحظة أن بياجيه استبعد الأسلوب الإحصائي في وصف هذه المراحل مفضلا الأسلوب الوصفي.
ويمكن تلخيص فكرة بياجيه عن النمو فيما يلي:
1- هناك استمرارية محددة لكل عمليات النمو.
2- النمو يتقدم خلال عمليتي التعميم والتمييز (أي القدرة على ملاحظة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف) وتتصف هاتان العمليتان بالاستمرارية.
3- الاستمرارية تتصف بأنها عملية تفتح أي أن ما يحدث في مرحلة نمو ما قد مهد له في المرحلة السابقة كما أنه يمهد للمرحلة التالية. أي أن صفة الاستمرارية موجودة في كل مرحلة.
4- كل مرحلة تتضمن تكرارا للعمليات التي تمت في المراحل السابقة، ولكن بتنظيمات مختلفة.
5- التنظيمات المختلفة هذه تكون ترتيبا تصاعديا (أي متزايدا) للخبرات والأفعال عند الأفراد.
6- الأفراد يحققون مستويات متباينة داخل هذا الترتيب التصاعدي .... ولو أن لكل فرد القدرة على اكتساب كل الخبرات وإمكانية أداء كل الأفعال التي يمكن للفرد ( أي الأطفال) تحقيقها في مثل أعمارهم.
وقد قسم بياجيه مراحل النمو العقلي إلى أربع مراحل أساسية هي:
1- المرحلة الحسية الحركية: The Sensorimotor Stage : وتشمل السنتين الأوليتين من حياة الطفل، أو من الميلاد وحتى يبدأ الكلام. وقد أطلق عليها بياجيه اسم المرحلة الحسية الحركية لأن الطفل خلالها يكون مشغولا بحواسة وأنشطته الحركية.
وقد تعرضنا للكتب الثلاثة التي تناول فيها بياجيه هذه المرحلة.
2- مرحلة التفكير التصوري أو مرحلة ما قبل العمليات The Per-operational Stage : وتشمل الفترة من عمر السنتين حتى السابعة. وقد اهتم بياجيه بهذه المرحلة وبخاصة السنوات الأخيرة منها ودرسها دقة بالغة وبشكل لم يتكرر في دراسته لمرحلة أخرى من مراحله النمائية ابتداء من الميلاد حتى النضج.
وحيث أننا هنا نركز على تربية الطفل قبل المدرسة الابتدائية وبالذات في مرحلة رياض الأطفال. فسنتناول هذه المرحلة بشيء من التفصيل لشرح سبب تسميتها (مرحلة ما قبل العمليات). ومعنى مصطلح (العمليات) وخصائص تفكير الطفل في هذه المرحلة وتطبيقات كل ذلك تربويا.
3- مرحلة العمليات المحسوسة أو العيانية The Concrete Operations Stage : وتشمل الفترة من السابقة حتى الحادية عشرة.
4- مرحلة العمليات التشكيلية أو المنطقية The Formal Operations Stage : وتشمل الفترة من الحادية عشرة وما بعدها.
بياجيه .... وما قبل المدرسة.
وتنتهي المرحلة الحسية الحركة ويكون الطفل قد نظم خبراته إلى الدرجة التي يستطيع فيها محاولة استخدام طرق جديدة ليتعامل مع مواقف جديدة عليه. وهو هنا لا يستخدم ما لدية من صور ذهنية عامة كانت تفيده في التصرف في مواقف مشابهة. أي أن هناك نموا عقليا حادثا عند الطفل.
ويتركز تفكير الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية على تمكنه من استخدام الرموز التي تمكنه من الاستفادة أكثر من خبراته السابقة. وهو هنا يستطيع التعامل عقليا مع أشياء سبق تعامله معها حسيا وجسميا. إذ أن بياجيه يؤمن بأن الرموز تشتق من عملية تقليد ذهني وأنها تتضمن صورا بصرية وكذلك احاسيس جسمية. والآن الرموز تؤسس على ما لدي كل طفل من خبرات سابقة فإنها _ أي الرموز - تختلف من طفل إلى آخر. فقد يرمز الطفل لصوت صادر من عجلة سيكل بكلمة هي رمز مشتق من خبرة سابقة فقد يكون هذا الصوت كطنين نحلة عند طفل وقد يكون دوران ساقية عن طفل آخر. مثال آخر .... كل طفل يدرك معنى الدراجة (العجلة) ولكن لكل طفل فكرته الخاصة المنفردة عن " العجلة " ذلك لان خبرات الأطفال عن الدراجات (العجلات) مختلفة.
إذن فالكلمة كرمز لها " عند كل طفل " معنى خاصا. ويرى بياجيه أن من أهم سمات اللغة والفكر عند الأطفال الصغار هي الخصوصية أو التمركز حول الذات. أي أن الطفل يستقل بفكرته ولا يهتم بفكر أو رأى غيره، فهو يترجم الكلمات ويستخدمها حسب ما لدية من خبرات سابقة. ولا يدور بخلد الطفل أن لغيره من الأطفال والكبار أفكارا ومدركات تختلف عما لدية.... وذلك لاختلاف خبرات كل منهم. أن يكون للطفل قدرة على إدراك أن لغيره فكرة ولغة خاصة بهم وقد تختلف عن فكرته ولغته هو. فهذا ما يسمى باللغة والفكر الاجتماعي، أو التفاعل الاجتماعي وهو أمر لا يظهر عنده ألا في سن السابعة أو الثامنة.
ولا ينتج فكر ولغة الطفل المتمركزين حول ذاته من مجرد طريقته الفردية في فهمه الكلمات ومعانيها. ولكنهما ينتجان أيضا من عدم قدرته على التفكير في أكثر من شيء واحد في الوقت الواحد. وعدم قدرته هذه تؤثر بشكل واضح على منطق تفكيره.
وقد شغلت هذه المسألة بياجيه شغلا كبيرا مما دعاه إلى إجراء تجارب عديدة لتحديد درجة فهم الأطفال لمبدأ الثبات أو الحفاظ " Constancy " ويعنى أن المادة لا تتغير بتغير شكل أو هيئة الشيء.
ففي إحدى التجارب هناك وعاءان متماثلان تماما في الشكل والسعة وبكل منهما كمية متماثلة من سائل له لون واحد. أمام عيني الطفل تم تفريغ السائل الموجود في أحد الوعاءين المتماثلين في إناء ضيق وطويل، ووضع محتوى الوعاء الثاني في إناء متسع ومنخفض- أن كمية السائل واحدة في كلا الوعاءين- قال الطفل أن كمية السائل في الإناء الضيق الطويل أكثر من كمية السائل في الإناء المنخفض الواسع. الطفل هنا يرى أن الإناء الطويل به سائل أكثر لأنه يركز فقط على شيء واحد إلا وهو الطول أي الارتفاع. إذ يره الطفل أن هذا الإناء يحوي مقداراً من السائل أكثر لأنه أطول. وقد يقول بعض الأطفال أن الإناء الأقصر يحوي مقدارا أكبر من السائل لأنه أوسع، أن قدرة الطفل العقلية فى هذه المرحلة لا تمكنه من إدراك علاقتين في وقت واحد. أي الطول والاتساع، ولا بد من مضى سنتين أو ثلاث في عمر الطفل حتى يستطيع أن يتخلص من تركيز انتباهه على شيء واحد، وعندئذ يمكنه أن يفكر عقليا في شيئين في وقت واحد مثل الطول والسعة في التجربة السابقة. وحينئذ يمكن للطفل أن يفهم أن كمية السائل هي واحدة سواء وضعت في إناء طويل أو قصير أي لا تتغير الكمية بتغير شكل الإناء.
ويتدرج الأمر في نمو الطفل حتى يستطيع الوصول إلى تعميمات مرتبطة بمبدأ الثبات في الكم والحجم والوزن، (سوائل – عجائن الصلصال – عدد من حبات الفول فهي تظل كما هي ولو تغيرت الصور أو الإشكال التي تتحول إليها. أي أن وزن كتلة من الصلصال قطعت إلى عدد من الكرات يظل وزنها كما هو بعد أن كانت كتلة واحدة وصارت مثلا عشر كرات صلصاليه صغيرة).
ويطلق بياجيه تعبير (العملية أو العمليات) ليصف الطريقة التي يمكن للطفل بها تفهم معنى الثبات (ثبات الكم – ثبات الحجم). فيعرف العملية بأنها فعل داخلي يشكل موضوع المعرفة. وأهم صفات هذه العملية قابليتها للانعكاس. أي عودة الشيء إلى وضعه الأصلي فى دهن الطفل.
وطفل مرحلة قبل المدرسة لا يستطيع عقله أداء هذه العملية، ولذلك أطلق بياجيه على مرحلة النمو هذه مصطلح مرحلة ما قبل العمليات. أن الطفل هنا لا يستطيع أن يدرك أن ما كسبه السائل في الارتفاع لم يفقده في الاتساع. فكمية السائل لم تتغير في الإناء المرتفع عنها في الإناء المتسع. وهو لا يستطيع تصور عودة السائل إلى الوعاء الأصلي حتى يتأكد عقليا أن الكمية لم تتغير.
ومع اقتراب الطفل من سن دخول المدرسة الابتدائية يبدأ ما أسماه بياجيه مرحلة العمليات المحسوسة أو العينية. وما زالت عملياته العقلية مرتبطة بالأشياء المادية التي يستطيع أن يدركها بحواسه، ولكنه لا يدرك الصفات المشتركة والعامة بينها مما يساعده على إجراء عملية التعميم.
وكما أن الطفل في مرحلة ما قبل العمليات يكون متمركزاً حول ذاته في لغته وتعبيراته. ومحددا في تفكيره نتيجة لهذا التمركز الذاتي، فان أحكامة أيضا تتأثر به فهو لا يستطيع أن يأخذ في اعتباره آراء ووجهات نظر غيره – سواء من الصغار أو الكبار ولا يستطيع أن يفكر إلا في شيء واحد في وقت واحد.
أطلق بياجيه على هذه الصفة تعبير " الواقعية الأخلاقية " يوضح المقصود بها في المثال التالي:
الطفل (أ ) أراد أن يملا القلم من دواة للحبر فسقطت بعض قطراته على مفرش فلطخة. هنا كان الطفل يريد أن يعاون في ملء القلم بالحبر. طفل آخر (ب) يلعب بقلم والده دون إذن منه فسقطت منه قطرة صغيرة عل المفرش، سئل طفل في رياض الأطفال أي الطفلين (أ ) أو (ب) خطؤه أكبر، نتيجة لتركيز طفل هذه المرحلة على شيء واحد ( في هذه الحالة حجم بقعة الحبر) فان حكمة الاخلاقى يكون ضد الطفل (أ ) . والذي كانت دوافعه أفضل إذ كان يريد أن يعاون والده – بأن يملأ له قلم حبره. وسميت بالواقعة الأخلاقية لأن الطفل يركز على الجانب المادي للموقف أي واقعه.
وتتمثل مركزية تفكير الطفل حول ذاته أيضا عندما يفسر القوانين والأوامر التي يتعرض لها. فهو يفسرها دائما من وجهة نظره هو في ضوء خبراته هو، وإذا بدي لنا أن الطفل يخالف الأوامر أحيانا فقد يرجع ذلك لعدم فهمه لوجهة نظر الآخرين وما يقصدونه. فهو لا يطيع الأمر لأنه فهمه بطريقته الخاصة (أي أنه لم يفهمه تماماً).
بياجيه .... والسؤال الأمريكي.
لقد طاب لعدد من العلماء في غرب أوروبا وعبر الأطلسي في الولايات المتحدة الأمريكية ما خرج به بياجيه من وصف لمراحل نمو الطفل العقلي. وربما تحمس بعض الأمريكيين لهذا التحديد الدقيق لتلك المراحل التي ثبت صدقها وجدواها عند بعض العلماء الأوروبيين الغربيين. لكن هؤلاء الأمريكيين انتهزوا الفرصة، وكان السؤال الأمريكي الشهير: كيف يمكن أن نسرع في نمو الطفل عبر تلك المراحل؟ أن بياجيه ترك الأطفال يفعلون ولاحظ أفعالهم من هدى طبيعتهم ومن خلال بيئتهم. وحدد مراحل النمو. ولم يفكر في أن يسرع في دور الفطرة، بل تركها تفعل ما تفعل في نمو الطفل في بيئته. وشاركه في هذا الرأي بعض الأمريكيين الذين تشربوا نطرتيه وآمنوا بأفكاره في فهم ووضوح، ومنهم دافيد الكايند ، وهيربرت جينسبرج ، وسيلفيا اوبر. وقد أزعجهم ذلك السؤال الأمريكي وهو كيف نسرع في عملية النمو، أو الإسراع في التعلم.
ويرى بياجيه أن أي محاولة في التعجيل بالنمو العقلي ليست فقط غير محتملة النجاح، ولكنها أيضا محفوفة بالخطر. وفى مقابله أجراها الكايند مع بياجيه وكان موضوعها هذا السؤال الأمريكي، لخص العالم السويسري رأيه في القول التالي:
" في دنيا التربية .... يجب أن يتاح للأطفال أقصى قدر ممكن من النشاط الذاتي باستخدام الأجهزة والأدوات التي تمكنهم من تحصيل المعارف والمعلومات. إذ يمكنهم في العمليات المنطقية – الرياضية أن يفهموا ما يصلون إليه بأنفسهم. وإذا حاول الكبار أن يسرعوا في إحداث هذا التعلم فان الأطفال سوف يحرمون من لذة اكتشاف المعلومات بأنفسهم ولذلك تقل فاعلية ذلك التعلم المفروض عليهم.
ولهذا فلا جدوى من محاولات هذا الإسراع في النمو. ونحن لا نضيع وقتا عندما يبذل الطفل مجهودا طويلا لاكتشاف المعلومات، وذلك لأنه يكون مجموعة من العادات والاتجاهات العقلية التي من شأنها أن تختصر الوقت في عمليات مستقبلية.
إذن فالطفل يفهم معنى الرقم والعمليات الحسابية تبعا لدرجة نموه العقلي وفى وقت مناسب لهذا النمو. أما ما يفرض عليه من الكبار لتعلم ذلك المفهوم والضغط عليه والتبكير فيه... فأن كل ما يحدث أن الطفل يحفظ أو يعرف، ولكن الفهم مفقود. وخير من كل هذا أن يكتشف الطفل بنفسه وفى وقت نموه العقلي المناسب.
لو حاولنا أن نسرع في عملية التعلم عند الأطفال في تحد لمرحلة النمو العقلي التي وصل إليها الفرد فإننا نجد أنفسنا أمام احتمالين:
(أ ) احتمال أن يحول الطفل الخبرة إلى شكل يمكنه أن يتمثله تبعا لخبرته السابقة وقد يكون هذا التمثل مغايرا لما يريد له الكبير أن يتعلمه.
(ب) احتمال أن يتعلم مجرد رد فعل آلي لمثير ما دون أن يفهمه أو يستوعبه. وهذا التعلم ضعيف في أثره ولا يمكن استخدامه في عمليات التعميم أو في مواقف مستقبلية. كما أنه سرعان ما ينسى.
لهذا فلا يجب الإسراع في تعليم الطفل سواء داخل المدرسة أو خارجها فهناك أسماء لا يمكنه تعلمها في سنة ما لأن التكوين المعرفي عنده غير مستعد لهذا التعلم. وإذا حدث واجبر الطفل على هذا التعلم فالنتيجة أن يوصف هذا بأنه تعلم سطحي وغير أصيل وغير نافع. بل إن ما يتصور الكبار أن الطفل قد تعلمه هو على جانب كبير من الخطأ فأثره وقتي ومحدود.
وينصح بياجيه ومعاونوه بأنه بدلا من هذه المحاولات الكثيرة للإسراع في التعلم أن يفهم المربون أن (القدرة تحدد التعلم) وأن معظم أفكار الطفل لا تتكون عنده عن طريق التلقين والحفظ. ولكنها تكتسب تلقائيا. وأن على المدرسين أن يتعرفوا على مرحلة النمو التي يمر بها أطفالهم حتى يهيئوا الأنشطة المختلفة التي تساعدهم على أن يتعلموا بأنفسهم. ولان الأطفال يختلفون في تفكيرهم عن الكبار فجدير بهم أن يتعلموا من زملائهم الأطفال أيضا لابد أن تتاح لهم فرصة التعلم بالاكتشاف Discovery learning .
وتمر السنون:
ويستمر بياجيه الذي جاوز الثمانين من عمرة في أبحاثه دون كلل، يلاحظ ويدون ويضيف إلى المعرفة.
وتستمر آراؤه في الانتشار وتكتب عن أفكاره الرسائل العلمية، وتعلو مدرسته شأنا وإن ظهر من لهم آراء لا توافقه تماما.
وفى يم 16 سبتمبر 1980 فقدت الأوساط العلمية واحدا من أبرز علماء القرن العشرين.... جان بياجيه.
التدريس .... وعملية التربية:
هي نظرة من عالم أمريكي قريبة من ملامحها، بل وفى مضمونها إلى ما توصل إليه جان بياجيه. ولا بد لنا أن نعرف بأن دنيا النصف الثاني من القرن العشرين صارت صغيرة على الرغم من مساحتها التي لم تتغير. هي صغيرة بفضل وسائل الاتصالات التي قربت المسافات، ومن ثم صار في الإمكان الإسراع المذهل في انتقال الأفكار والآراء.
من جنيف في سويسرا صارت إشعاعات فكرية أثرت في كثير من الأقطار، والتقطتها عقول المهتمين واحتوائها في تفكير عبقري متمهل في تحمس.
من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية يبرز أستاذ في علم النفس وهو مدير الدراسات المعرفية في المجال التربوي، بآراء هزت التفكير الأمريكي المهتم بأمور التربية. وله إسهام كبير في تربية أطفال قبل المدرسة هو كبير وقريب الشبه بآراء بياجيه. ولهذا سنعرض له في عجالة.
هذا العالم هو جيروم برونر Jerome Bruner الذي فجر المناقشات التربوية الحادة بكتابه " عملية التربية " The process of Education في بواكير الستينات من هذا القرن. أما كتابه الذي أعطاه عنوان " نحو نظرية للتدريس " Toward a Theory of Instruction عام 1966م . فقدم فيه أسسا لتشكيل النمو العقلي عند الأطفال في نطاق مخطط مسبق وطويل الأمد. هذا المخطط الذي يتصف بأنه يتضمن تحديدا وتوصيفا لمراحل النمو العقلي يعكس اهتمام برونر بالهيكل البنائي للمعرفة. معنى هذا أن للمعرفة بناء له تكوين وتنظيم معينين. وهذا التكوين يجب أن يؤخذ في الاعتبار عندما يتعرض الطفل لتعلم المعرفة. ويقول برونر" نحن نفتقد وجود نظرية للتدريس توجه المعلم في العملية التربوية ... وأي نظريات فى نمو الطفل يجب أن ترتبط بنظريات المعرفة وأيضا بنظريات التدريس وإلا كانت قليله الجدوى ... بل وتافهة "
وفى نظريته في التدريس يرى برونز أن النمو العقلي يسير في ثلاثة أنظمة متتابعة موازية لمراحل النمو العقلي عند بياجيه. ولكنه يختلف عنه في تفسيره لدور اللغة في هذا النمو. إذ يرى بياجيه أن اللغة والفكر مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولكن كلا منهما يعتبر نظاما مستقلا، وأن تفكير الطفل إنما يبني على أساس من منطقه الذاتي الذي يتكون ويتبلور من خلال تنظيمه لخبراته. وهو – كما سبق القول – يؤمن بأن الرموز التي يستخدمها الطفل تنشأ مما يراه حوله وما يقلد، من بيئته. في حين يرى برونز أن الفكر هو لغة داخلية في عقل الطفل أي كامنه فيه. وأن تركيبات اللغة عند الطفل هي التي تتحكم في فهمة لمبدأ الثبات وغيره من المبادئ أكثر مما يتحكم المنطق.
وثمة اختلافات أخرى بين برونر وبياجيه لعل من أبرزها موقف كل منهما في التفكير الرمزي والتخيل عند الطفل. وفى قضية مدى المساعدة التي تقدم للطفل للتفكير في مستويات أعلى. وفى مدى تأثير البيئة المحيطة على النمو العقلي. وفى إمكانية الإسراع فيه وهو الاختلاف بين الرأي السويسري والسؤال الأمريكي، يقول برونز في هذا الصدد ... أن فكرة الاستعداد هي في الواقع نصف حقيقة لعوب. فلو تركت الطبيعة في مسراها لصار الطفل مستعدا عندما يكون نموه العقلي مهيأ. لكن إذا أردت أن تستخدم طرائق وامكانات تعين الطفل فقد تنجح في أن تأخذ بيده حتى يكون مستعداً، أي يصل إلى مرحلة الاستعداد العقلي. ويتم هذا بلعبة طريفة هي تهيئة بيئة فيها من اللعب والأجهزة والإرشاد الذكي مما يمكنه من بلوغ هذا الاستعداد، هذا رأى برونر الذي يؤكده في عبارته المعروفة .... " إننا (ندرس ) الاستعداد ولا نقف متفرجين انتظاراً لحدوثة ".
خصائص طفل ما قبل المدرسة:
ومن وحي ما سبق من آراء بياجيه وغيره من المعاصرين سوف نحاول إلقاء الأضواء على الصفات أو السمات البارزة لنمو أطفال مرحلة ما قبل المدرسة ومقترحين بعض الإجراءات التربوية التي تواكب هذا النمو. مع ملاحظة أننا نتناول خطوطا عريضة وليس المقصود في ها المقام التعرض المفصل لا للصفات ولا للإجراءات التربوية التطبيقية.
أولا : الصفات الجسمية:
1- يتصف أطفال هذه المرحلة بالنشاط الجسمي الزائد ، ولديهم قدرة طيبة على التحكم في حركاتهم الجسمية، ويستمتعون بالحركة لذاتها ولذلك هم دائبو النشاط الجسمي.
* يتطلب هذا منح الأطفال فرصا كثيرة للجري والقفز والتسلق شريطة أن تعد المشرفة الظروف لإمكانية تحقيق هذه الأنشطة وتحت إشرافها. ويصعب هذا الإشراف إذا كان عدد الأطفال كبيراً. وهنا تحتاج المشرفة إلى مساعدة أو أكثر.
2- ينزع أطفال هذه المرحلة إلى تفجرات نشاطية وينسيهم النشاط أنهم في حاجة إلى الراحة من فرط سعادتهم بهذا اللهو المحبب إليهم.
* يجب أن تعد المشرفة البرنامج بحيث تتنوع النشاطات فيعقب كل نشاط جسمي حاد نشاط آخر خفيف، ثم يخصص وقت يستمتع فيه الأطفال بالراحة. فقد يعقب جرى وقفز مشاركة في لعبه جماعية تستخدم فيها ألعاب تعليمية أو آلات موسيقية مناسبة.
3- تنمو العضلات الكبرى عند الأطفال أكثر من تلك العضلات التي تتحكم في حركات الأيدي والأصابيع. وذلك فقد لا يوفقون في أداء حركات تتطلب مهارات يدوية دقيقة كإحكام وضع (الزر في العروة) أو ربط الأحذية .... الخ.
* تستبعد المرشدة في تخطيطها أنشطة تتطلب مهارات يدوية دقيقة مثل قص ولصق الأشكال الصغيرة بالورق أو الرسم بفرشاة رفيعة ... وأن توفر لهم الفرش والأقلام الكبيرة سهلة الاستعمال.
4- يجد الصغار في رياض الأطفال صعوبة في تركيز أبصارهم على الأشياء الصغيرة.... لذلك يفتقدون القدرة على التوافق الدقيق بين العين واليد.
* نقلل بقدر المستطاع تعرض الأطفال للتعامل مع الأشياء الصغيرة دقيقة الحجم. ولذا فيجب أن تكون الصور وأشكال الحروف إذا وجدت كبيرة الحجم .... وعلى العموم فواجب استبعاد التعامل مع الأشياء الصغيرة.
ثانيا: الصفات الاجتماعية للأطفال:
1- يتميز أطفال هذه المرحلة بالمرونة في علاقاتهم الاجتماعية. فهم يلعبون ويمارسون الأنشطة مع معظم زملائهم من الأطفال. وقد يكون للطفل صديق أو صديقان مقربان. ولكنه ينتقل من صداقتهما إلى صداقات أخرى وبسرعة. ويفضل الأطفال أن تكون الصداقة مع نفس الجنس أي البنات مع البنات والأولاد مع الأولاد. وهذا لا يمنع من أن تنمو صداقات بين الأولاد والبنات.
* على المرشدة أو المشرفة أن تلاحظ باستمرار الأطفال في نشاطهم لتقف أمام حالات الانزواء أو عدم المشاركة في النشاط. إذا قد يفضل بعض الأطفال ملاحظة الغير لا مشاركتهم النشاط. وقد يفضل الطفل الابتعاد عن المجموعة وقد يكون السبب خجلا منه أو عدم ثقته بنفسه. وهنا يجب على المرشدة أن تتدخل بالتشجيع والمساعدة. وقد تستخدم في مثل هذه الحالات بعض الأساليب العلمية كالسوسيوجرام الذي يصف العلاقات بين أفراد المجموعة بعضهم البعض.
2- تتصف مجموعات اللعب بأنها صغيرة العدد أي أن عدد أفرادها قليل وليست محكمة التنظيم. وعلى ذلك فهي سريعة التغير.
* على المرشدة ألا تنزعج إذا أكثر الأطفال من تغيير أنواع الأنشطة التي يمارسونها، أي ينتقلون من لعبة جماعية إلى نشاط آخر ثم إلى آخر والى آخر وهكذا. وهذا سلوك طبيعي ومتوقع من أطفال هذه المرحلة. وقد يسبب ذلك للمرشدة إزعاجا ومتاعب. ولكنها طبيعة الأطفال وعلينا أن نتحمل كل هذا بصدر رحب. وقد يدور بفكرنا أن نحاول ضبط هذه التنقلات من نشاط إلى آخر ... وهذا آمر طيب، ولكن يجب أن نراعى أنه يحدث أحيانا من بعض المرشدات إصرار على استمرار الطفل في نشاط معين ولا يتركه إلى نشاط آخر، وقد يحدث في هذه الحالة أن يتحول الطفل إلى سلوك فيه تمرد.
3- قد تحدث مشاجرات ومنازعات بين الأطفال. وهذا أمر طبيعي ومتوقع، ولكن الجميل أن هذه المشاجرات مداها قصير. فالأطفال يتشاجرون وسرعان ما يتصالحون.
* ولنتصور مرشدة أو مشرفة ومعها ثلاثون طفلا. والألعاب والأجهزة التعليمية محدودة. وللأطفال حقوق ورغبات في استخدام هذه الألعاب والأجهزة. من المتوقع أن تحدث مشاحنات طفيفة كأن يتنازع طفلان فيريد كل منهما أن تكون الكرة مثلا من نصيبه. على المرشدة إلا تتدخل ألا في الحالات التي يحتدم فيها النزاع. وهنا تحول انتباه الطفلين المتنازعين إلى شيء آخر. وقد سبق لنا الإشارة إلى واقعة بين طفلين تنازعا على كرة فدعتهما المشرفة إلى الاشتراك في نشاط آخر فرميا الكرة وانهمكا في ذلك النشاط. انقشعت سحابة النزاع وسطعت شمس الوفاق ولذلك فليس من التربية أن تعلب المرشدة دور الحكم بين الاطفال.
4- يميل أطفال هذه المرحلة إلى التمثيل. ومعظم ما يحاولون تمثيله ينبع من خبرتهم التي ترتبط بحياتهم مع أسرهم وبالحكايات التي يستمعون إليها سواء من أفراد أو من خلال أجهزة الإذاعة أو من البرامج التليفزيونية.
* على المسؤول على روضة الأطفال أن يفهم بوعي هذه الصفة في نمو الصغار اجتماعيا. ويحاول أن يشبعها بما لديه من قدرات ابتكارية، فقد يؤلف موقفاً دراميا (والدراما تعنى المأساة والملهاة، أي أن المشاهد الجادة والضاحكة كلها تندرج تحت كلمة دراما)، وتحكي للأطفال القصة وتوزع الأدوار. ويقوم الصغار بالتمثيل. يرى البعض أن تمثيل الصغار لأدوار العنف قد يكون متنفسا لما لديهم من كبت نفسي. ويرى البعض الآخر أن هذا النوع من التمثيل ينمى لدى الأطفال النزعات العدوانية. ومهما كان الأمر فان الأطفال يحبون التمثيل ولعب الأدوار وقد يكون من المفيد لهم أخلاقيا أن يعد المسئولون مواقف تمثيلية ذات أهداف خيرة وهادفة نحو تنمية اتجاهات يرتضيها المجتمع.
ثالثا – الصفات الانفعالية للأطفال:
1- يعبر الصغار في رياض الأطفال عن انفعالاتهم بطريقة صريحة وفى حرية. مع ملاحظة أن انفعالات الغضب تتكرر كثيرا لديهم.
* أنا طفل لي إحساساتي ورغباتي، دعونى أعبر وأفصح عنها ولا تعاملوني كما تعاملون الإنسان الراشد الذي يستطيع بحكم خبراته وارتباطاته في المجتمع أن يخفف من غلواء انفعالاته. أنا لست مثله. واشعر بالارتياح عندما اغضب وانفجر غضبا. هذا قد يريحني. افهموني. سوف تقولون لي أن هناك حدودا. ربوني وعلموني هذه الحدود. لكنني أحب عندما أغضب أن اعبر عن غضبى.
أنا لا أنسى غضبت على زميلي فضربته، وجاءت إلى المشرفة وكانت مازالت باسمة الوجه، ولكنها سألتني سؤالا كان غريبا بالنسبة لي، إذ قالت لي هل فكرت قبل أن تضربه ماذا تكون النتائج؟ أنا في مثل سني لا أفكر بهذه الطريقة، أنا غضبت فضربت، ربما بعد ذلك أتعلم أن هذا خطأ وعندئذ لن افعل ذلك مرة أخرى.
جلست إلى نفسي وقد ساءني ما فعلت مع زميلي. وعندما ذهبت إلى منزلي لاحظ والدي ما أنا عليه وحكيت له الحكاية من البداية. لم يغضب منى وقال لأمي إن ابنك يغضب عندما يكون متعبا أو جائعا، أو عندما نكثر نحن او غيرنا من الكبار_ الضغط عليه والتدخل في تصرفاته أكثر من اللازم، لم افهم ما قاله والدي، ولكنني أعرف أن ما أقوله الآن، ربما سأفهمه فيما بعد.
إذا فهمني الكبار فسوف يعرفون أن هذه مرحلة في عمري وسوف تمر. ويحاولون تخفيف ما يقع على من ضغوط، هم يسمونها ولا افهمها (مثيرات للغضب) تنتهي عندما ادخل المدرسة الابتدائية.
2- نظرا لأن أطفال هذه المرحلة يتعرضون لمواقف كثيرة جديدة عليهم، ونظرا لان خيالهم واسع وجامح فلذلك تكثر وتتضخم مخاوفهم وأوهامهم. ولذلك يجب أن نعرف - أن هذه المخاوف أمر طبيعي في حياة الطفل في هذه المرحلة، فلا تسخري منها ولا تقللي من شأنها وخذي الطفل بالهدوء، إن كبت هذه المخاوف بأقوالك هو أمر لن يخلص الطفل منها، وأن ظهر ذلك لك. ولكن عواقبه في المستقبل وخيمة فقد تظهر في مخاوف مرضية (Phobias ) أو إحساسات عامة بالقلق.
ولهذا فإن على المعلمة أن تستمع بإنصات لان الأمر شديد الأهمية ويجب عليها ما يلي:
- ألا تسفه بالقول أو بالإشارة من مخاوف الطفل.
- ألا تدفعه إلى نفس الموقف الذي سبب له الخوف.
- ألا تتجاهل ما يذكره الطفل عن مخاوفه.
وواجب عليها أن تشعر الطفل بتقديرها له ولمشاعره، وأن ثبت فيه الإحساس بالأمن والطمأنينة.
المعلمة هي النموذج الذي يقتديه الطفل في كل تصرفاتها وحتى في مخاوفها.
عليها ألا تجبر الطفل على عمل ما يثير لديه تخوفا، بل عليها أن تتركه يلاحظ غيره من الأطفال في نفس الموقف، وعلى قدر استطاعته يحاول تقليدهم دون ضغط أو أكراه منك له لعمل شيء يثير تخوفه.
3- الغيرة بين الأطفال في هذه المرحلة أمر شائع وبخاصة عندما يطلبون الإحساس التعاطفي من المشرفة نحوهم. وهذا انفعال طبيعي إذ أن الأطفال يكثرون من حبهم لمشرفهم أو مرشدتهم، ويحاولون الحصول على رضاهم عنهم سواء بالقول أو الفعل. والأمر لا يختلف إذا كان الذي أمامهم مشرفا أو مشرفة. وتوقعي أو توقعك أيها المشرف. أن الغيرة بين الأطفال حادثة فلا يعقل أن يوجد ثلاثون طفلا وأمامهم راشد ولا يسارعون إلى رضاه واستجداء عطفه، ولذلك فهم يتنافسون للحصول على الرضا والقبول.
* على المعلمة أن تكون عادلة وأمينه (بقدر استطاعتها) عندما توزع عطفها وقبولها وانتباهها واستحسانها بين الأطفال. وعليها أن تقلل بقدر المستطاع من التمجيد والاستحسان العلني والمبالغ فيه لطفل أمام غيره من الأطفال. ولتتذكر إحساسها عندما كانت صغيرة وتسمع هذا الإطراء والإعجاب الشديدين لزميل أو زميلة لها. هل أحسست أيتها المرشدة بالغيرة؟
رابعا: الصفات العقلية:
1- لدى الصغار في رياض الأطفال مهارة عالية في اللغة. ويحب معظمهم التكلم وبخاصة أمام مجموعة.
* جدير بالمعلمة أن تتيح أكبر عدد من الفرص والوقت ليتحدث الأطفال أمام زملائهم. والأمر الهام هنا ليس في القدرة على الكلام والتحدث، ولكن فى القدرة على السكوت والاستماع أيضا. وهذه القدرة تحتاج إلى بذل المجهود من المشرفة لمساعدة الأطفال على تعلم كيف ينصتون ويستمعون.
وتستطيع المرشدة أن تعود الأطفال في حالات تكلم فرد أمام مجموعة أن يكون هناك صوت واحد. أما أن يكون صوت المتكلم فينصت الآخرون أو صوت واحد من المستمعين فيصمت المتكلم. هو صوت واحد في وقت واحد.
وجدير بالمعلمة أن توازن بين رغبة الطفل الذي يحب الإكثار في الكلام وبين آخر لا يجب الكلام وبين ثالث لا يجد الفرصة للتحدث أمام المجموعة، أي لا تعطى واحد وتحجب الفرص عن غيره.
ويمكن أن تعد ظروفا خاصة يجد فيها الأطفال الخجولون فرصا للمرور بخبرات شيقة (القيام بزيارة – مشاهدة فيلم ..... الخ) بحيث تعطيهم زادا من المعلومات يشعرهم بشيء من الثقة والأمن إذ هم في هذه الحالة يعرفون أكثر مما يعرفه غيرهم من الأطفال فتدب فيهم الشجاعة للتحدث أمامهم.
2- قدرتا التخيل والابتكار في قمتيهما في هذه المرحلة.
يجب أن تنمى تلك الصفات من خلال اللعب والرسم وقص القصص حيث إن البعض يفتقدون القدرة الابتكارية والتصورية عندما يكبرون في العمر الزمني. وهذا يظهر أحيانا في سلوكهم وهم يعملون في وظائف تتطلب أحيانا تصرفات معينة.
ولو أن بعض الأطفال يقعون نهبا لعدم قدرتهم على التمييز بين الخيال والواقع مما يؤدى إلى مشكلات ترتبط بتكيفهم الاجتماعي وعلاقاتهم مع غيرهم صغارا كانوا أم كباراً.
أن جموح خيال الأطفال قد يدفعهم إلى اختراع حوادث وقصص لم تحدث، ولكنها مبنية على أفكار سولت لهم مخيلاتهم أمورا تحولت إلى تخيلات هي من محض أفكارهم. أن دور المشرفة هنا شديد الأهمية فعليها أن تبذل الجهد لوضع اللجام فى فم الحصان الجامح. وهذا أمر جد عسير، ولكن المحاولة فيه ضرورية، فقد تحدد الوقت المخصص لقص القصص لتتيح لهذا الطفل أن يسرد ما يريد قولة. وقد يكون فى هذا تحديد لانطلاقات خياله وخاصة أنه يعرف أن بعض المستمعين قد لا يقبلون تماما ما يقوله.

